التوظيف البراجماتي: كيف استغلت “الإخوان” الولاء والبراء للهجوم على المتحف المصري الكبير؟
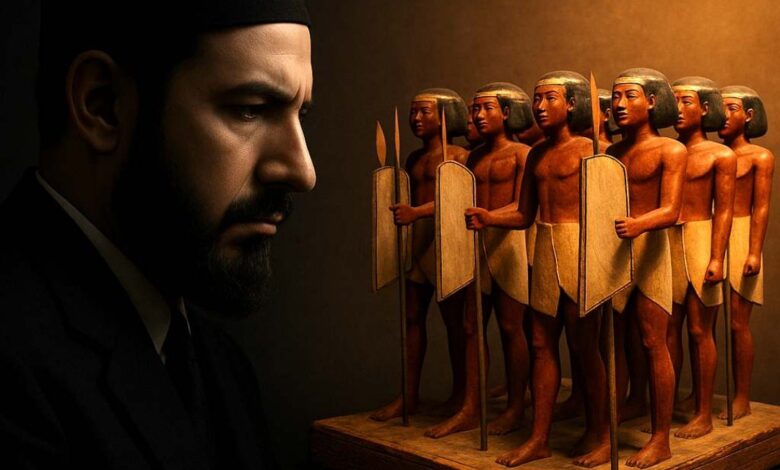
تحوّل افتتاح المتحف المصري الكبير – الذي يُعد حدثًا ثقافيًا وإنسانيًا استثنائيًا في تاريخ مصر – إلى ساحة هجوم ديني–سياسي، بعد انتشار فيديو للشيخ مصطفى العدوي عبر “إنستجرام” يعلن فيه وجوب التبرؤ من فرعون، ويحذر من الاحتفال بمن مات على الكفر. أعقب ذلك حملة ممنهجة قادتها حسابات وشخصيات إخوانية وسلفية، أبرزهم محمد ناصر، وأُسامة جاويش، وسلامة عبد القوي. بعض التصريحات اعتبرت افتتاح المتحف تمجيدًا للطاغية وردة إلى عبادة الأصنام.
وقد كشفت الواقعة عن تلاقي الفكر الإخواني السياسي مع التأصيل السلفي الذي ينظر إلى الآثار بوصفها بقايا شرك يجب طمسها لا حفظها.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن جماعة الإخوان وأعوانها لم يتمكنوا من الحفاظ على ثباتهم النفسي تجاه مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي أبهر العالم، فتخلّوا عن استخدام مفهوم التقية في هذا الموقف، وأشهروا سلاح مفهوم الولاء والبراء.
ما سبق، يدعو إلى طرح عدد من الأسئلة، هي: كيف استخدمت الجماعة مفهوم الولاء والبراء لتأطير الحملة؟ وكيف اعتبرت الآثار أصنامًا في الخطاب الأصولي؟ وما الجذر السلفي لهذه الفكرة؟ وكيف التقت المرجعية السلفية بالعقيدة الإخوانية في تبرير الحملة؟
تأصيل أصولي:
استخدمت جماعة الإخوان مفهوم الولاء والبراء وفق تأسيس حسن البنا في صراعها الذي قادته في حملتها ضد افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ حددت دوائر الانتماء والعداء في المجتمعات، وقسمتها إلى الولاء لله والجماعة، والبراء من الجاهلية وأنظمتها – وفق تعبيرهم.
استدعت الجماعة في الحملة ضد المتحف هذا المفهوم، فقسمت تأسيسًا عليه المصريين إلى فئتين: فئة مؤمنة ترفض الاعتزاز بتاريخها وتراثها الحضاري، وفئة كافرة أو منافقة تمجّد الطغاة والأصنام. وبهذا انتقل مفهوم الولاء والبراء من دائرة الإيمان والكفر العقدي إلى دائرة الإيمان والكفر انطلاقًا من الهوية الثقافية والتاريخية. بناءً على ذلك، صوّر أعضاء الجماعة – عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وقنواتهم – المتحف على أنه رمز للشرك، وألصقوا بالرئيس السيسي وصف فرعون الجديد.
تلك المفاهيم بين المؤمن الموالي والطاغية المتأله هي جزء من الرموز العاطفية في أدبيات سيد قطب، الذي يعد الحاكم – أي حاكم يخالف الفكر الإسلامي الحركي – فرعونًا معاصرًا، وتصبح معارضته واجبًا دينيًا لا موقفًا سياسيًا.
تفسيرا لما سبق وتوضيحا له، يمكن تحديد أبرز الأطر الفكرية التي استندت إليها الحملة الإخوانية من أدبيات سيد قطب في عدد من النقاط، هي:
(*) مفهوم الجاهلية الجديدة: قدّم سيد قطب في كتابه معالم في الطريق تصورًا يقوم على الفصل بين المجتمع الإسلامي والمجتمع الجاهلي، معتبرًا أن الجاهلية ليست مرحلة تاريخية مضت، بل حالة فكرية وسلوكية تعود كلما ابتعد الإنسان عن منهج الله. ومن هذا المنطلق، تعتبر الجماعة أن الحضارة القديمة – ومنها الحضارة المصرية – رمز للوثنية والضلال، وهو ما انعكس في تصريحات رفض تمجيد المتاحف أو الاحتفاء بالآثار.
(*) تطبيق مفهوم الولاء والبراء: شدّد قطب في سياق تفسيراته القرآنية – خاصةً لسورتي الكافرون والممتحنة – على أن الولاء لا يكون إلا لله ورسوله والمؤمنين، وأن أي مظهر من مظاهر التقدير لحضارة غير إسلامية يعد خروجًا عن مقتضيات العقيدة. وقد شكّل هذا التصور الخلفية الفكرية التي انطلقت منها الخطابات الإخوانية الرافضة للاحتفاء بالمتحف المصري الكبير، حيث اعتبرت ذلك انحرافًا عن صفاء التوحيد وموالاةً لرموز وثنية.
(*) نقد الحضارة المادية: يرى قطب في كتابه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته أن الحضارة التي تقوم على تعظيم المادة أو تمجيد الإنسان، سواء كانت قديمة أو حديثة، إنما تنحرف عن جوهر الرسالة الإلهية. ومن هذا المنطلق، تُقدَّم الحضارة الفرعونية في أدبيات الإخوان باعتبارها نموذجًا للحضارة المادية التي قامت على عبادة الملوك لا على توحيد الخالق، وهو ما استخدمه عناصر الجماعة لتبرير الهجوم على المتحف المصري الكبير، واعتباره مظهرًا من مظاهر الوثنية المعاصرة.
المنهج السلفي في التعامل مع الآثار:
لفهمٍ أعمق لطبيعة الحملة وخلفيتها العقدية، يقتضي الأمر بيان المنهج السلفي في التعامل مع الآثار. فالمدرسة السلفية النجدية (الوهابية) – أكثر المدارس تأثرًا بفقه سد الذرائع عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب – ترى أن ما يُحاط بالتقديس أو الإعجاب في التراث المادي قد يفضي إلى عبادة غير الله. ولهذا اعتبر أغلب فقهائهم أن التماثيل والآثار القديمة مظانٌّ للشرك، مستشهدين بحديث ضعيف: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور». ويستدل الفكر السلفي بهذا الحديث على تحريم التصوير والنحت، ومن هنا حرّموا إقامة التماثيل أو إبراز الآثار الفرعونية باعتبارها – وفق تصورهم – ذريعة إلى الشرك.
تحليلًا لهذا الفكر يمكن القول، إن المنهج السلفي يفقد القدرة على قراءة النصوص في سياقها التاريخي والمقاصدي، فيصطدم بالجمود وتقديس حرفية النص. فالمرويات التي وردت في النهي عن الصور والتماثيل تُقرأ على ضوء الظروف التي وُجدت فيها التماثيل بوصفها رموزًا لعبادة الأصنام، لا على أنها حكم مطلق ضد الفنون أو التراث الحضاري في المجمل.
ففي عهد النبي ﷺ كانت التماثيل تُعبد والصور رمزًا للشرك، ولهذا جاء النهي لحماية العقيدة الجديدة من الارتداد إلى الوثنية. أما اليوم فالتماثيل والآثار لم تعد تُعبد، بل تُعرض في المتاحف باعتبارها معالم سياحية تمثل أحد مظاهر القوة الناعمة للدول، وينظر إليها بوصفها رموزًا علمية وثقافية وتاريخية.
تأسيسًا على هذا المنهج الأصولي، اعتبرت التيارات المتطرفة أن التمثال الفرعوني في المتحف امتدادٌ للصنم الجاهلي في مكة قبل الإسلام، وأصبح حفظ الآثار والاعتزاز بها إحياءً للوثنية. ومن هذا المنطلق كتب سلامة عبد القوي – الإخواني الذي يرتدي عمامة الأزهر في تركيا ويفتي بناءً على رمزية هذا المظهر – في منشوراته على منصة إكس أن إحياء الفرعونية ردة عن الإسلام الأول، وأن المسلم لا يجوز له أن يفخر بعبادة الأصنام.
فالخطاب الأصولي إذن لا يميز بين الرمز التاريخي والمقدس الديني، لأن بنيته الفكرية قائمة على نفي المجاز وتمجيد الحرفية. وبهذا المعنى، فإن الهجوم على المتحف ليس هجومًا على حدث بعينه، بل رفضٌ فلسفي للذاكرة الحضارية، لأن تلك الذاكرة تهدد السلطة المطلقة للموروث وحرّاسه. فكل أثر يذكّر الإنسان بقدرته على الإبداع والعلم يضعف الحاجة إلى وسيط ديني يفسر له التاريخ باسم السماء.
تلاقٍ أيديولوجي:
رغم ما يبدو من اختلاف بين السلفية بتفريعاتها والإخوان كجماعة دينية سياسية حركية، فإن الحادثة الأخيرة كشفت عن عمق التلاقي الفكري بينهما، رغم العداء الظاهر أحيانًا بفعل تضاد المصالح.
فالسلفيون قدّموا الأساس العقدي (تحريم الفخر بالآثار واعتبارها أصنامًا)، بينما وظّف الإخوان ذلك سياسيًا لتحريض هدفه إسقاط شرعية الدولة ومؤسساتها الثقافية.
بعبارة أخرى، يرى السلفي أن المتحف شرك في العقيدة، ويرى الإخواني أنه شرك في الطاعة والولاء، أي تمجيد للطغيان والطغاة.
والنتيجة واحدة في المسارين: نزع القيمة عن التاريخ الوطني وتحويل الإنجاز الحضاري إلى خطيئة دينية. فهذا التحالف بين تقديس الحرفية السلفية والأيديولوجيا الإخوانية ليس جديدًا، وقد انعكس أثره في حقب متعددة. يمكن ذكر أمثلة على تطبيق هذا الفكر، على النحو التالي:
(-) تحطيم تماثيل بوذا في باميان – أفغانستان (2001): حطّمت حركة طالبان التماثيل في مارس 2001، وصرّحت بأن ذلك تطبيق للتوحيد ورفض لعبادة الأصنام.
(-) تدمير آثار في سوريا (2015): دمّرت داعش تماثيل تاريخية وفجّرت المعابد الرومانية القديمة في مدينة تدمر، مبررة ذلك بأنه تطهير من الوثنية وهدم للأصنام.
(-) تدمير الأضرحة في مالي (2012): نفّذه تنظيم أنصار الدين التابع للقاعدة، فهدم أكثر من 14 ضريحًا ومقامًا تاريخيًا بدعوى محاربة الشركيات والبدع.
(-) محاولات استهداف التماثيل والمتاحف في مصر بعد 2013: انتشرت دعوات من بعض المنابر السلفية والإخوانية تدعو إلى هدم التماثيل باعتبارها مظاهر وثنية.
بناءً على ذلك، فإن المشهد المثار في الأيام السابقة من قِبل اللوبي الأصولي يتكرر بنفس المفردات التي استخدمتها تلك الجماعات، وهو انعكاس للفكر المتطرف ذاته. فالهدف الرئيسي منه تجريد الهوية المصرية من بعدها الإنساني، لتبقى هذه الجماعات وحدها مالكةً لمعيار الولاء والبراء.
وبينما تنظر الدولة إلى المتحف بوصفه أداةً للقوة الناعمة تسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية، يراه الخطاب المؤدلج رمزًا للجاهلية، لأن الحضارة الفرعونية في نظره تزاحم المرجعية الدينية في قيادة الوعي الجمعي.
فالهوية المصرية الحديثة قائمة على ثلاث ركائز متكاملة: الإسلام كمرجعية روحية، والعروبة كامتداد ثقافي، والفرعونية كجذر حضاري. لكن الخطاب الإخواني–السلفي يعجز عن استيعاب هذا التعدد لأنه يفترض أن الإيمان يرفض التراكم الثقافي، وأن ما سبق الإسلام يجب محوه لا دراسته. وعليه، يمكن تلخيص مرتكزات هذا الخطاب وغرضه في أربع نقاط:
1. التحريم العقدي: استدعاء النصوص التي تنهى عن عبادة الأصنام لتجريم حفظ الآثار رغم اختلاف المقصد والسياق.
2. التكفير الرمزي: تحويل مظاهر الفخر الوطني إلى مؤشرات للانحراف عن الدين.
3. استدعاء المظلومية: تصوير العدوي – ومن يروجون للخطاب ذاته – كـ “شهداء للحق”، لإثارة التعاطف الشعبي ضد الدولة وتغذية السردية القديمة عن اضطهاد رجال الدين.
4. التحريض الثقافي: توظيف الحدث الثقافي لتحقيق أغراض إخوانية واستثمار الخطاب الديني لإثارة الاستقطاب المجتمعي.
من مجمل ما سبق، يمكن القول إن حملة الإخوان والسلفيين ضد المتحف المصري الكبير تختزل جوهر الصراع بين الإسلام التنويري والإسلام الأيديولوجي؛ فالأول يرى أن الإيمان لا يناقض الحضارة، والثاني يختزل الدين في شعارات العداء والولاء لتحقيق مآرب سياسية، ويجعل من تحطيم الآثار رمزًا للإيمان، ومن حفظها خيانةً للعقيدة.
فهذا الخطاب المتطرف يعادي في جوهره فكرة الإنسان المنتج للمعرفة والجمال، لأنه يريد أن يظل المؤمن تابعًا لا صانعًا. ومن ثم، فإن الرد الحقيقي على هذه الحملة لا يكون بالجدال، بل ببناء وعيٍ ديني وطني راسخ، يربط بين التوحيد والعلم، وبين الإيمان والعمل، وبين الدين والهوية، دون أن يسمح لمنهج البراء من التاريخ أن يحوّل الذاكرة الحضارية إلى ركام.
فالمتحف المصري الكبير في رمزيته ليس بناءً من حجرٍ فحسب، بل إعلانٌ عن انتصار الإنسان المصري على ثقافة الهدم، وعن رفض تحويل الدين إلى سلاحٍ ضد الحضارة الإنسانية.



